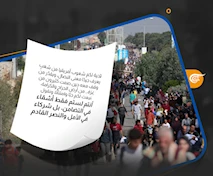حرب الكونغو ولعنة الثروات
بحسب الأمم المتحدة، فإن نصف مليون مواطن نزحوا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في شرقي الكونغو، الأمر الذي خلق وضعاً إنسانياً بالغ القسوة، خصوصاً أن ثلثي الشعب الكونغولي يعانون ضائقة اقتصادية بسبب الفقر.
-

جذور الصراع وأسباب تجدّده.
شأنها شأن الدول الأفريقية الغنية بالموارد والثروات، ظلت جمهورية الكونغو الديموقراطية - زائير سابقاً - تعاني بشدة الاضطرابات السياسية والأمنية، منذ أن نالت استقلالها عن بلجيكا في عام 1960، وعُرفت بتكرار الانقلابات العسكرية منذ عام 1965، وزاد تدخل دول الجوار في تلك الاضطرابات. وظل التنافس الدولي على ثرواتها عاملاً ثابتاً فيما تشهده من صراعات.
مع بداية هذا العام، بدأت الأوضاع في شرقي جمهورية الكونغو الديموقراطية تتفاقم، وخصوصاً بعد التقدم الذي حققته حركة "مارس 23" (23M) الكونغولية ـ المدعومة من رواندا المجاورة – عبر سيطرتها على غوما، أكبر مدينة شرقي البلاد، وتلويحها بنقل القتال إلى العاصمة كينشاسا، الأمر الذي دعا الرئيس فيليكس تشيسيكيدي إلى إعلان التعبئة العسكرية لمقاومة التمرد، وحمل حكومته على المطالبة بفرض عقوبات دولية على جارتها رواندا، بدعوى الحد من صراع المتمردين والمحافظة على السلام الإقليمي.
جذور الصراع وأسباب تجدّده
كان أول انقلاب عسكري جرى في الكونغو في عام 1965، حين استولى القائد العسكري، جوزيف موبوتو، على السلطة، فحكم البلاد حتى عام 1997، غيّر خلالها اسم الدولة من الكونغو إلى زائير، قبل أن يعيده لوران ديزيريه كابلا إلى سابقه.
على إثر عمليات الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا عام 1964، والتي راح ضحيتها نحو مليون مواطن رواندي من أقلية قبيلة التوتسي على أيدي مواطنيهم من قبيلة الهوتو، لجأ نحو مليوني لاجئ رواندي إلى الكونغو، فتأسست بين صفوهم حركة مناهضة للنظام الحاكم في كيغالي. من هنا بدأ تاريخ جديد من الصراع بين الجارتين، استمرت آثاره حتى اليوم، إذ ظلت رواند لاعباً خطيراً في الملعب الكونغولي، من خلال دعمها للجماعات المتمردة على النظام، وجعلت لنفسها من ثروات جارتها نصيباً.
يُعَدّ انقلاب كابيلا على الرئيس موبوتو سيسي سيكو عام 1997 واحدةً من نتائج التدخل الراوندي في الشؤون الداخلية للكونغو.
واجه كابيلا تمرداً عسكرياً بعد عام واحد من توليه السلطة، وكانت رواندا تقف وراء هذا التمرد بعد أن تمرد عليها لوران كابيلا الذي جاءت به إلى السلطة، وساءت العلاقات بين البلدين، وتراجعت الثقة بينهما، وتعزز مع ذلك عدم الاستقرار في الكونغو.
في مناخ عدم الاستقرار هذا، تناسلت حركات التمرد في شرقي الكونغو، حتى بلغت 120 حركة، بينها حركة "مارس 23" (23M)، وميليشيا ماي ماي، والقوات الديمقراطية لتحرير رواندا، والقوات الديمقراطية المرتبطة بتنظيم "داعش".
انتهت حالة من الهدوء النسبي في الكونغو حين سيطرت حركة "مارس 23" على مساحات شاسعة في مقاطعة شمالي كيفو، في شرقي البلاد، وتوترت الأوضاع بعد تحركها نحو عاصمة الإقليم، غوما، في صيف عام 2022، وفتحت باباً لتسعير الصراع. ومن أجل وقف هذا التقدم، طلبت الحكومة الكونغولية دعماً من مجموعة دول شرقي أفريقيا، التي نشرت قوة متعددة الجنسيات تُعرف اختصاراً بـــــــ (EACRF). ومع هذا التوتر تجددت اتهامات الكونغو لرواندا بدعم الحركة، ودَعَمَ محققو الأمم المتحدة هذا الاتهام.
في نهاية عام 2022، نجح تدخل بعض رؤساء دول المنطقة في إطلاق عملية عُرفت بــ "عملية لواندا"/ قضت بوقف إطلاق النار وانسحاب المتمردين، غير أن الحركة لم تنسحب من الأراضي التي احتلتها، واتهمت كينشاسا بمواصلة دعمها ميليشيات الهوتو المناهضة للحكم في رواندا. وهكذا، تجدد الصراع، الذي يمتد تهديده من شرقي الكونغو إلى رواندا، ومنهما إلى سائر دول منطقة البحيرات العظمى.
لعنة الثروات
الكونغو دولة فاحشة الثراء على رغم فقر مواطنيها، وأرضها ذاخرة بالثروات، ففيها 80% من احتياطيات العالم من معدن الكولتان، الذي يُعَدّ مكوناً رئيساً في صناعة الإلكترونيات، وهي المنتج الثاني للماس في العالم، والمنتج الأول للكوبالت عالمياً، إذ تستحوذ على 75% من احتياطيات العالم، كما تمتلك احتياطيات كبيرة من: الليثيوم والزنك، التنغستن، اليورانيوم، الحديد والنحاس. وتقدر قيمة هذه الثروات بــــــ 24 ترليون دولار.
وإلى جانب الثروات المعدنية، تمتلك كينشاسا ثروات طبيعية تجعلها مقصداً للأمن الغذائي إقليمياً ودولياً، إذ تبلغ نسبة الأراضي الصالحة للزراعة فيها 80 مليون هيكتار، يُزرع منها فقط 10 ملايين، وتُعَدّ أغنى دول القارة الأفريقية في المياه، بحيث تمثل ثروتها المائية 52% من الاحتياطي المائي الأفريقي. ويبلغ سكانها 77 مليون نسمة، 65% منهم من الشبابن، لكنهم، على رغم كل هذه الثروات، يرزحون في فقر مريع، إذ حوّلت الأطماع الإقليمية والدولية ثروات بلادهم إلى نَّقمَة، وجعلت ماضيهم وحاضرهم مثالاً على البؤس والشقاء.
التدخل الخارجي في الشأن الكونغولي
ما إن خرج المحتل البلجيكي حتى حل مكانه وجود خارجي يمثل، في أوجه من أوجهه، مظهراً من مظاهر الصراع على الكونغو الديموقراطية، إقليمياً ودولياً، فهو وجود متعدد الأشكال، بعضه عسكري، وبعضه اقتصادي، وجانب منه إقليمي، وجانب آخر منه دولي.
ومن الأمثلة على ذلك الوجود الإسرائيلي، الذي بدأ في عام 1962، من خلال تبادل الاعتراف وإقامة العلاقات الدبلوماسية، ثم اتخذ بعداً اقتصادياً استحوذت عبره "إسرائيل" على الاستثمار في مجال الماس لعقود مضت، حتى باتت محتكرة له تقريباً.
إلى جانب الوجود الإسرائيلي يوجد وجود لأميركا، وهو وجود قديم كذلك، تجسّد أول مظاهره في رعاية واشنطن للانقلاب على حكم الزعيم باتريس لوممبا واغتياله، وأسفر عنه التنافس الأميركي على ثروات هذا البلد، إذ يحتدم التنافس بينهما في مجال الكولتان والكوبالت، بصورة خاصة، وتعمل أكثر من 100 شركة صينية في هذا التخصص من الاستثمار، وتنافسها أميركا بشدة في هذا المجال. وحمَلها الاهتمام بالثروات الكونغولية إلى إطلاق مشروع ممر يُعرف بممر لوبيتو، يبلغ طوله 1300 كيلومتر، وممول منها بشراكة مع الاتحاد الأفريقي، وهدفه ربط الأحواض المعدنية بزامبيا، ثم بميناء لوبيتو في دولة أنغولا، والمطلّ على المحيط الأطلسي. وهذا الممر كفيل بتفسير القيمة الاستثنائية لهذه المعادن من جهة، وبتقديم صورة من صور التنافس الصيني الأميركي على القارة الأفريقية وثرواتها، من جهة أخرى.
أما مظاهر الوجود العسكري، فيمكن تمثيلها عبر البعثات الأممية التي بدأت في تموز/يوليو 1960، واستمر هذا الوجود حتى هذه الساعة دافعاً في اتجاه حفظ المصالح الغربية تحت ستار حفظ السلام.
لجيوش دول المنطقة وجود في الكونغو، ومن الأمثلة على ذلك، وجود جيوش رواندا، بوروندي، يوغندا، جنوب أفريقيا، وغيرها من الجيوش. ودخل بعض هذه الجيوش، بشكل منفرد، ودخل بعضها تحت غطاء منظمات إقليمية، كبعثة المجموعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، أو بعثة جماعة شرقي أفريقيا، والتي تُعرف اختصاراً بــــــ (EACRF).
الأثر الإنساني للأزمة
بحسب الأمم المتحدة، فإن نصف مليون مواطن نزحوا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في شرقي الكونغو منذ بداية هذا العام، وسبقهم في النزوح عن المنطقة نفسها نحو 6.5 ملايين مواطن، الأمر الذي خلق وضعاً إنسانياً بالغ القسوة، وخصوصاً أن ثلثي الشعب الكونغولي يعانون ضائقة اقتصادية وأزمات اجتماعية بسبب الفقر، الذي يضاعف عدمُ الاستقرار حِدّتَه، ويزيد في مساحة انتشاره.
آفاق الحلول
تشكل مبادرات الحلول الداخلية غياباً بائناً، إذ لم تبذل جهوداً داخلية كافية لإيجاد تسوية بين السلطة والمنظمات التي تمردت عليها، وهي مبادرات من شأنها أن تمهد الطريق من أجل تسوية شاملة، تشمل رواندا، وتمهد الطريق لعلاقات طبيعية على المسرح الكونغولي، وعلى صعيد العلاقات الثنائية الكونغولية الرواندية، لتنعكس بعدها إلى مصالحات إقليمية شاملة. وبالمثل، غابت المبادرات التي يمكن أن تنتج وئاماً بين الجارتين، إذ لم تبادر أي منهما إلى طرح مبادرة تحقق ذلك الوئام.
وشكل الاتحاد الأفريقي كذلك غياباً تاماً عن الأزمة حتى الآن، على الرغم من أنه بادر إلى التدخل في نزاعات شبيهة في القارة. ويُعزى هذا الغياب إلى التأثير الغربي الكبير في مفوضية الاتحاد الأفريقي، التي أفقدت هذه المنظمة استقلالها، حتى باتت تنتظر الإذن أو التوجيه من الغرب لتضطلع بأدوار منوط بها المبادرة إليها.
في الأثناء، انعقدت قمة في تنزانيا، يومي الـ7 والـ8 من الشهر الجاري، جمعت قادة تكتل دول شرقي أفريقيا، وقادة تكتل دول جنوبي أفريقيا، ناقشت الأزمة. ودعت القمة، في ختام مباحثاتها، إلى إجراء محادثات مباشرة لحل الصراع في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية بمشاركة متمردي حركة "مارس 23" المدعومة من رواندا.
وأكدت القمة التضامن والالتزام الثابت بشأن مواصلة دعم جمهورية الكونغو الديموقراطية في جهودها لحماية استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها. وأشار القادة إلى عزمهم إطلاق عملية سلام تقوم على انسحاب القوات المسلحة الأجنبية، التي دخلت، من دون مسوّغ، أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدين التزامهم حماية سيادتها. ويشي هذا النص بأن الاتجاه الغالب في تلك القمة نحا إلى تأكيد الاتهامات الكونغولية ضد رواندا، التي شارك رئيسها في هذه القمة، وهو أمر قد يقود إلى مزيد من الضغوط على كيغالي، وقد يعمق الاصطفافات الاقليمية في هذا الظرف، وخصوصاً أن بوادر هذا الاصطفاف كانت حاضرة في تلك القمة بين الأطراف المشكلة للكتلتين.
وقبل انعقاد القمة، حذرت الولايات المتحدة من عقوبات محتملة ضد المسؤولين الراونديين والكونغوليين، بعد أن سيطرت حركة "مارس 23" على مناجم الكولتان والذهب وخام القصدير في إقليم كيفو الشمالي. كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن القتال في جمهورية الكونغو الديمقراطية بين المتمردين والحكومة قد يعصف بالمنطقة بأسرها.
الأمن الإقليمي
إن الصراع الدائر شرقي الكونغو الديمقراطية يُعَدّ أزمة إقليمية، أكثر من كومه أزمة داخلية، وهي أزمة مركّبة شديدة التعقيد، لا تعود جذورها فقط إلى صراعات قبلية أو نزاعات محلية، وهي ليست انعكاساً لمشكلات تاريخية بين دول جارة فقط، كما أنّها لا تعبّر فقط عن مخاطر الفلسفة، التي رسم الاحتلال الغربي بموجبها خرائط الدول السياسية، والتي تأسست على زرع بذور الأزمات حين رسم الحدود السياسية للدول من دون مراعاة للتاريخ والمعطيات الاجتماعية وانعكاساتها المستقبلية على الأمن والاستقرار، إنما هي مجموع كل ذلك في ظل الصراع الدولي على الموارد في قارة أفريقيا، التي هي، وفق كل التقديرات، قارة المستقبل بما تحويه من موارد وثروات.
ينفتح هذا الصراع على مخاطر كبيرة على الأمن الإقليمي، وخصوصاً أن قمة قادة الكتلتين الأخيرة لاحت فيها نذُر الانقسام بين كنشاسا وكيغالي، وبرزت فيها دولة جنوب أفريقيا مناصرة للكونغو، وخصوصاً بعد مقتل 13 من جنودها العاملين في الكونغو، ضمن بعثة سلام إقليمية، على أيدي قوات حركة "مارس 23" حين اجتاحت مركز التجارة في مدينة غوما، الأمر الذي حدا برئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إلى تحذير رواندا من دفع بلاده إلى إعلان الحرب.
ولئن لم تتدارك المبادرات الإقليمية الأمر في الكونغو، فسيتطور الصراع، وقد يتجاوز شعاع قُطر النار منطقة البحيرات، لتطال شرورها بعض دول إقليم الجنوب الأفريقي، في ظل مواقف دولة جنوب افريقيا، والتي تمت الإشارة إليها.