مراجعة كتاب فهم الفهم: مدخل إلى الهرمنيوطيقا
يعتبر الفيلسوف فريدريك دانيال أرنست شلاير ماخر (1768-1834) أن الهرمنيوطيقا هي "علم" الفهم أو "فن" الفهم ولا يعتبرها مجموعة من القواعد اللغوية تترابط فيما بينها نسقياً.
-
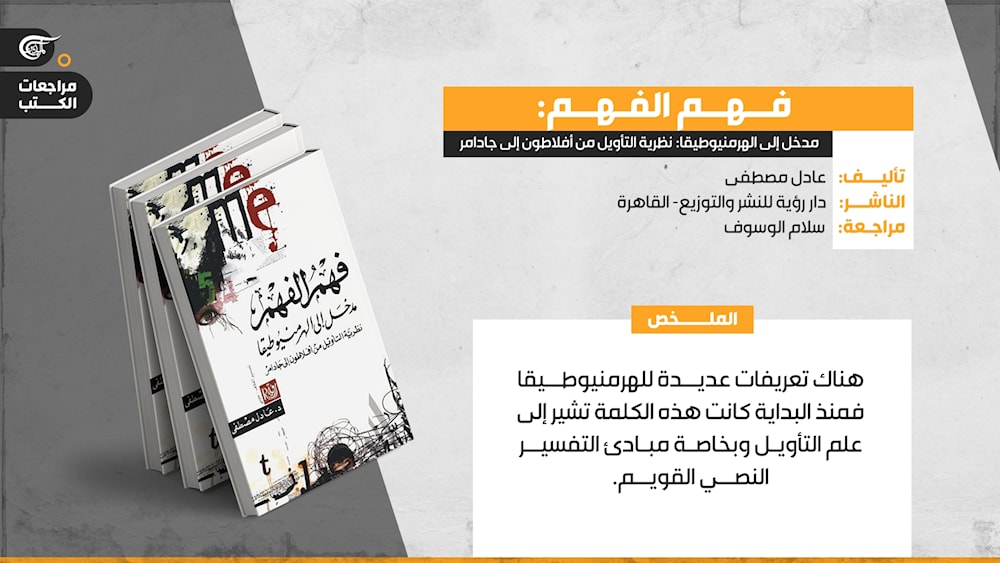
كتاب: "فهم الفهم: مدخل إلى الهرمنيوطيقا" لعادل مصطفى
من قدر الإنسان حقاً أن يتخذ موقفاً تأويلياً من وجوده الخاص، ومن قدر البشر، بقدر ما يكونون بشراً حقيقيين، أن يستمعوا إلى الرسالة... أن يُصغوا إليها وينتموا إليها بوصفهم بشراً.
أفلاطون: في محاورة أيون
الهرمنيوطيقا هي مصطلح فن الفهم، انبثق من الفعل اليوناني Hermeneuein ويعني " يفسر " أما لغوياً فهي تتعلق بالإله " هرمس Hermes رسول آلهة الأولمب الرشيق الخطوة، الذي كان بحكم وظيفته يتقن لغة الآلهة ويفهم ما يجول في خاطر هذه الكائنات الخالدة، ثم يترجم مقاصدها وينقلها إلى أهل الفناء من بني البشر. وانطلاقاً من هذا، لا بد لنا من أن نتذكر عندما قرأنا الإلياذة والأوديسا لهوميروس، أن الإله هرمس كان ينقل الرسائل من زيوس كبير آلهة اليونان وينزل بها إلى مستوى البشر، الأمر الذي كان فيه يقلّص المسافة الفاصلة بين تفكير الآلهة المقدسة التي لا تخطئ، وبين البشر الذين يؤوّلون الكلام والفهم.
تحكي الأسطورة أن هرمس كان يقوم بهذه المهمة، متخفياً بخوذة سحرية، وكان لديه خفّان مجنحان لكي يحملاه بعيداً وبسرعة، عابراً المسافات، مع عصا يتمكن من خلالها أن يُنيّم أيّ أحد ويوقظ أيّ أحد. ويتخطّى العالم المرئي، بين الوعي واللاوعي، هرمس مرشد الأرواح إلى العالم السفلي، ومن ثم يعبر الخط الفاصل بين عالم الأحياء وعالم الموتى. فهو إله التخوم وأعتاب كل شيء. في العصر الحديث يطلَق هذا المصطلح على مناهج فهم النصوص الدينية والدنيوية معاً، ويدرس كل العمليات المتعلقة بالفهم وبالتحديد فهم النصوص وشرح كل ما هو مستور وسرّي ومخبّأ، فهل تزول صراعاتنا الفكرية عندما يقبل الإنسان بمفهوم أخيه الإنسان، وإذ كان ذلك حقيقة فعلاً، لماذا قال فريدريك نيتشه لا توجد حقائق، بل توجد تأويلات. ماذا يعني أن تكون عدة تأويلات للفكرة ذاتها على مختلف العصور، أليس يعني أن النصّ حيُّ ويقبل ما لانهاية من الرؤى والتحليلات، وهذه الرؤى تؤسّس لحرية الإنسان القادم. الذي يحيا ضمنياً عصره ويعبر عن وجوده. فإذا سلّمنا بهذه الفلسفة البسيطة كمدخل لموضوعنا، سنعود من جديد ونؤكّد أن فهم الفكرة بقوالب عديدة يذيب التناحرات، لذلك يجب أن يرتقي الهرمسي بألية الفهم ويرتقي بنقلها من دون صراع. المؤلف عادل مصطفى يتحفنا بهذه الجولة الفكرية ضمن نظرية فهم الفهم أو نظرية التأويل.
ضمن كتاب الفيلسوف مارتن هايدجر " الطريق إلى اللغة " يتناول الصلة الوثيقة بين معنى الهرمنيوطيقا وبين شخصية هرمس، فيقول : إّنه لممّا يحمل أعمق المغزى وأبلغ الدلالة أن هرمس هو رسول الآلهة، وليس رسولاً مجرداً بين البشر بعضهم لبعض، ذلك أن الرسالة التي يحملها هرمس ليست رسالة عادية، إنّه يحمل الخبر الصاعق والنبأ المجلجل. فالتأويل في أسمى معانيه، هو أن تكون قادراً على فهم هذه الأنباء المقدورة، وأن تفهم قدرية الأنباء. يريد هايدجر هنا أن يحثّ المفسر على التأمل في النصوص بحب فقيه للألفاظ: وأن يعطي كل لفظة في كل موضع وزنها الكامل، والذي يكون في الأغلب خفيّاً مستوراً". مشروع هايدجر ينطوي على استعادة فهم الوجود واسترداد الوعي به، والذي يرى أننّا افتقدناه في الأزمنة الحديثة، بل منذ زمن أفلاطون وأرسطو، وعلى الهرمنيوطيقا أن تكون من وجهة نظره " مزلزلة للعالم " أي رسالة جليلة تزعزع أسس الفكر، وتحدث كما يقول تحولاً في "الفكر ".
في هذا الكتاب يقدم لنا الكاتب تعريفات أخرى للهرمنيوطيقا. إذ كانت بداية تشير إلى علم التأويل، وخاصة فيما يتعلق بمبادئ التفسير النصي القويم، أما حديثاً فقد امتدّ ليشمل العديد من التأويلات: كنظرية تفسير الكتاب المقدس، ومنهجية فقه اللغة العام، وعلم كل فهم لغوي، والأساس المنهجي للعلوم الإنسانية ( الروحية)، وفمينولوجية الوجود والفهم الوجودي. وأنساق التأويل ( سواء كان تراكمياً أو تحطيمياً) التي يستخدمها الإنسان للوصول إلى المعنى القابع وراء الأساطير والرموز.
ومن الملاحظ بان كل تعريف من هذه التعريفات يشير إلى أكثر من مرحلة تاريخية، أو ما يسمى مدخلاً إلى مشكلات التأويل بحد ذاتها، لتصبح على التوالي، التأويل الإنجيلي" والفقهي اللغوي، والعلمي، والإنساني، والوجودي، والثقافي. حيث نلاحظ أنه مع تغير الزمن، يتم فرز وجهات نظر جديدة تبعاً لتغير التأويل. فعلى سبيل المثال لو أخذنا مسألة الـتأويل الإنجيلي، يقول الكاتب: مع ظهور حركة الإصلاح الديني البروتستانتي عام 1527 والتي قادها المصلح مارتن لوثر، الجاهدة إلى ترجمة الكتاب المقدس من اللغة اللاتينية إلى اللغة الألمانية، كي يتسنى لجميع أفراد الشعب أن يطّلعوا عليه و بالتالي الابتعاد عن احتكاره من قبل رجال الكنيسة، من دون أي مساعدة منهم. وبالنظر إلى تعداد التفسيرات الممكنة لأي نص إنجيلي، دعت الحاجة إلى تأسيس ما يسمى معايير التفسير الصحيح. وكان على الهرمنيوطيقا أن تكون باستمرار علماً لهذا التأويل . فالفيلسوف باروخ سبينوزا في كتابه " رسالة في اللاهوت والسياسة " للكتاب المقدس يقول " ليس للكتاب المقدس معيار آخر غير ضياء العقل الذي يعمّ كل شيء " والفيلسوف لسنج يقول "إن الحقائق العرضية للتاريخ لا يمكن أن تصبح براهين على الحقائق الضرورية للعقل"، وما أراد قوله هو ربط الكتاب المقدس بالإنسان العقلاني المستنير. الأمر الذي أدى إلى عقلنة المقولات الإنجيلية ، و إخراجها من رتبة القداسة والتقييد اللغوي التي كان من غير المعقول المساس بها.
إذا توغلنا أكثر في شرح هذه المفاهيم وتناولنا الهرمنيوطيقا بوصفها علم الفهم اللغوي. يقول الكاتب: إن الفيلسوف فريدريك دانيال أرنست شلاير ماخر(1768-1834) أعاد تصوير الهرمنيوطيقا على أنها "علم" الفهم أو"فن" الفهم وأن لا يعتبرها مجموعة من القواعد اللغوية تترابط فيما بينها نسقياً، بل بجعلها علماً يصف الشروط اللازمة للفهم في أيّ حوار، وأن تتسع لأن نطلق عليها هرمنيوطيقا عامة أي دراسة الفهم ذاته. وإذا تناولنا الهمرمنيوطيقا بوصفها فيمينولوجيا الفهم الوجودي، يقدم الفيلسوف مارتن هايدجر ضمن كتابه " الوجود والزمان" 1927 الذي يعد تحفة الكتب والمفتاح الحقيقي لفهم فكره الفلسفي في مينولوجية للوجود اليومي للإنسان في العالم، وأطلق على تفسيره هذا اسم "هرمنيوطيقا الدازادين" أي بمعنى أشمل يبيّن فيه فيمينولوجيا الوجود الإنساني. إذ يقول: إن "الفهم" و"التأويل" هما طريقتان أو أسلوبان لوجود الإنسان، من منطلق أن الفهم ليس شيئاً يفعله الإنسان بل هو شيء يكونه، وبهذا عمق هايدجر مفهوم الهرمنيوطيقا والهرمنيوطيقي في "الوجود والزمان".
أما الفيلسوف الألماني هانز جورج جادا مير (1900-؟) تلميذ هايدجر، فقد طور مفهوم الهرمنيوطيقا إلى عمل نسقي في كتابه "الحقيقة والمنهج" عام 1960 الذي يعدّ أهم الأعمال التي أُنتجت في القرن العشرين ويتعقب فيه تطور الهرمنيوطيقا من شلايرماخر إلى دلتاي، وهايدجر مجرّباً ربط الهرمنيوطيقا بعلم الجمال وبفلسفة الفهم التاريخي، وبأن لا تكون بعيدة عن الأسئلة الأبستمولوجيا أو الأنطولوجية.
يعرّج الكاتب في هذا الكتاب الفاخر أيضاً على الهرمنيوطيقا في عصر التنوير. تلك الفترة التي تناولت الفكر الأوروبي المتسم بروح جديدة من الثقة بالعقل والشك في كل سلطة تقليدية، وبزوغ تدريجي لأفكار الحرية والديموقراطية وفصل السلطات، والتعويل على المنهج والتجربة، والتفاؤل والإيمان بالتقدم التاريخي البشري من خلال التربية، وبوادرها التي بدأت في إنكلترا في القرن السابع عشر مع كتابات فرنسيس بيكون وتوماس هوبز، وفي فرنسا مع رينه ديكارت الذي أكد قدرة العقل وحده على الوصول إلى جميع الحقائق العسيرة المنال، والذي بلغ ذروته مع الموسوعيين في فرنسا، ومع ديفيد هيوم وآدم سميث في إسكتلندا، ومع ألمانيا مع عمانوئيل كانط، وكذلك مع مونتسكيو الذي تأسس دستور الولايات المتحدة على أفكاره.
كذلك مُثّلتْ الهرمنيوطيقا في عصر التنوير عند "كلادينيوس 1710-1759" بأنها فن تقني ضروري للدراسات التي تعتمد على تأويل النصوص: من التاريخ، إلى الشعر، واللاهوت. القانون، الإنسانيات، باستثناء الفلسفة باعتبارها شكلاً من أشكال الجدال المحض أو الاعتبار النقدي للأفكار، بقوله: إن أيّ نص طالما أنه يبتعد عن الكذب والخداع فمن شأنه أن يرمي إلى إفهام القارئ أو المستمع النص كاملاً مع فهمه فهماً حقيقياً.
وهكذا أرى أنّ الكتاب جميل جداً يقدم لنا مفهوم شلايرماخر، ودلتاي، وهسرل، وهايدجر، وجاداماير، وهيرش، وهابرماس وبول ريكور، وماركس ونيتشه. وليس في وسعنا عرض الفكر الهرمنيوطيقي عند كل هذه القامات الفلسفية، لكن من شأننا، وهذا ما نصوّب عليه أن تكون المراجعة استقطابية تدعو القارئ لأن يتمعن بهذه النظرية "نظرية التأويل" وكيف تطرّق إليها هؤلاء الفلاسفة عبر العصور.
يُنهي الكاتب عادل مصطفى الكتاب بالمحاورة التاريخية الجميلة لأفلاطون "محاورة إيون". وأنا أُنهي بقول لهيدجر: إن لغتي هي مسكني ، وهي موطني ومستقري، وهي حدود عالمي الحميم ومعالمه وتضاريسه، ومن نوافذها ومن خلال عيونها أنظر إلى بقية أرجاء الكون الواسع .
نشير إلى أن الطبيب والمترجم النفسي المصري عادل مصطفى له ثلاثون كتاباً، حائز جائزة ( أندريه لا لاند) في الفلسفة وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية (الفلسفية المعاصرة).













